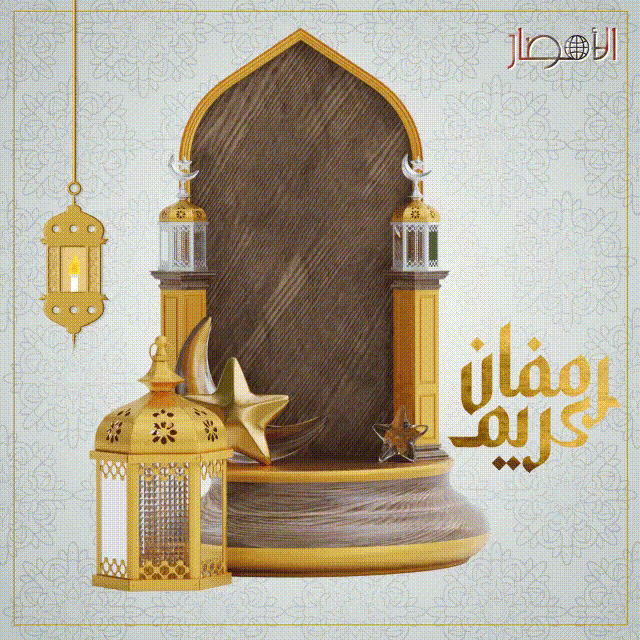قوى التغيير في السودان: هل بدأت ترتيب اوراقها لكسر جمود الموقف؟

الخرطوم: محجوب الطيب
لعل ما قاد إلى حالة السيولة التي انتهت بانقلاب يكمن في أن القوى التي قادت الثورة “ترفّعت” عن قيادة الدولة، وعبّدت الطريق أمام النادي السياسي القديم ليعيد إنتاج فشله، ومنحته حق تقرير مصيرها. ثم أن القوى الحديثة لا تملك الخبرة الكافية لإدارة الدولة، ولم يتخلق منها تنظيم سياسي ينتقل بها من قيادة الثورة إلى قيادة الدولة.
كان من الطبيعي أن تنتهي حالة السيولة السياسية، والعسكرية والأمنية التي سيطرت على المشهد السوداني بانقلاب عسكري يعيد الأوراق إلى مربع الصفر.
لم يكن انقلاب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، فجر الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي مفاجئاً للمتتبع لصراع أطراف السلطة الانتقالية، المدنيين والعسكريين، والذي خرج إلى السطح متفجراً قبيل موعد انتقال الرئاسة إلى المكون المدني في نوفمبر الجاري. لكن لم يكن هذا الصراع وحده هو الحاسم، إذ وبالمقابل، كان صراع “تحالف الحرية والتغيير” نفسه، والانقسامات التي طالت هذا التحالف الهش عاملاً حاسماً في انقضاض العسكر على السلطة بحجج تشظي القوى السياسية وانقساماتها، علاوةً على انكبابها على المحاصصات داخل جهاز الدولة.
طرح البرهان عدة مبررات لانقلابه على شركائه المدنيين، على رأسها الانشغال الغميس بالمحاصصات، وفشلها في تحقيق الحد الأدنى من الوفاق السياسي الذي يؤهلها أن تكون جسماً موحداً مؤهلاً لعملية انتقال الرئاسة للمكون المدني. يعلم البرهان تماماً أن “الحرية والتغيير” لم تكن مستعدةً للحظة انتقال الرئاسة بسبب الخلافات الحادة بين مكوناتها، وإنْ كانت هذه الخلافات قشرية، إلا أن الجنرال استطاع توظيفها لصالحه، ذلك بتغذيتها عبر دعم طرف ضد آخر.
اصطفت بعض قوى “الحرية والتغيير” إلى جانب العسكر، وأبرزها “حركة العدل والمساواة” برئاسة جبريل إبراهيم، و”حركة تحرير السودان” برئاسة مني أركو مناوي، وهي أبرز حركات دارفور المسلحة التي وقّعت على اتفاق جوبا للسلام في أعقاب سقوط البشير. مضت هذه المجموعات في خلافاتها إلى اللجوء للشارع، حينما حشدت بعض المكونات القبلية للاعتصام أمام القصر الرئاسي. وقد فتح لهم البرهان أبواب القصر الذي ظل الوصول إلى منطقته عصياً على قوى الثورة على مر المواكب والمليونيات التي تجوب الخرطوم منذ ما قبل سقوط البشير، باعتباره منطقةً محرمٌ الدخول إليها. لكن حينما انفتحت الأبواب واستضاف القصر هذه المجموعات، كانت الرسالة واضحةً تماماً ومفضوحة: إن اعتصام القصر هو تمهيد للانقضاض بحجج أن شارع الثورة ليس واحداً، وهناك شارع يرغب صراحةً في أن يمسك البرهان بكل السلطة، وقد كان هذا مطلباً رئيسياً لذلك الاعتصام الذي كان يعج بخطاب الكراهية ضد المدنيين، وفعلياً فهو قد لعب دور “المُحلل” لانقلاب البرهان.
سخط الشارع… الرسالة الخاطئة
صحيح أن السخط تسلل إلى الشارع جراء تراخي حكومة حمدوك في اتخاذ القرارات، وأنه تمدد أكثر ضد “الحرية والتغيير” التي أدارت ظهرها للناس متناسيةً مطالب ثورتهم، غير آبهة بشيء إلا بإدخال كوادرها إلى مؤسسات الدولة، وتحقيق مكاسب حزبية آنية، بعيداً عن العمل لتأسيس مدنية دولة خرجت بعد لأي من حكم العسكر. وصحيح أن كل ما احتج به البرهان لا تشوبه شائبة، لكن الجنرال ليس الشخص المؤهل أخلاقياً لتصحيح كرّاسة شريكه المدني، ليس فقط لأنه جزء من هذا الفشل بحكم الشراكة بينه وبين المكوّن المدني، بل لأن البرهان يخاطب مخاوفه الشخصية من محاكمة محتملة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، ويريد أن يجعل البلاد رهينةً لضمان سلامته، تماماً كما فعل الرئيس المخلوع عمر البشير بعد اتهامه من قبل محكمة الجنايات الدولية عام ٢٠٠٩م
ويبدو أنه فهم بشكل خاطئ سخط الشارع ضد القوى السياسية، وظن أن أي إطاحة بهم سوف تجد القبول. ولا يغيب عن الشارع السوداني انقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تربطه علاقات وطيدة اليوم بقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان. فقد نال السيسي في المواكب والتظاهرات ضد انقلاب البرهان نصيباً وافراً من الهتافات واللافتات المناوئة، وهي كذلك طالت دولة الإمارات، وهو المحور ذاته الذي نصح البرهان بفض اعتصام القيادة وفرض الأمر الواقع بالقوة، ظناً منهم أن الأمر يسير. لكن الشارع قابل محاولة البرهان للسيطرة آنذاك بعصيان شلّ الحياة تماماً، فاضطر الجنرال للرضوخ والتراجع. وتحت الضغط الإقليمي والدولي تمّ التوقيع على وثيقة دستورية بين العسكريين والمدنيين أفضت لشراكة في أغسطس 2019. لكن نية الانقلاب ظلت مبيّتة.
يتكرر اليوم المشهد ذاته، وفي ظن الناصحين أن الشارع وقواه الحية فقدت جذوة الثورة بعد عامين ويزيد من الفشل والعجز الذي أصبح سمة المشهد السوداني، فإذا بهم يشجعونه على انقلاب “يتيم”، لا غطاء له حتى داخل مؤسسة الجيش نفسها.
ودون التنبؤ بعمر انقلاب البرهان، والذي لا يختلف اثنان حول قصره، من الضروري الآن أن تقرر قوى التغيير في السودان أن يكون آخر الانقلابات في هذه البلاد التي لم تستطع الخروج من تقلبات الديمقراطيات الهشة والانقلابات منذ استقلالها في 1956، أو ما اُصطلح على تسميته في القاموس السياسي السوداني ب”الحلقة الشريرة”، وهي ديمقراطية هشة تنتهي بانقلاب عسكري ينتهي بانتفاضة شعبية، ثم ديمقراطية، فانقلاب ثم انتفاضة.
شهد السودان انتفاضتين أكتوبر1964، أبريل 1985) أطاحتا بحاكمين عسكريين قبل أن تنقلب الجبهة الإسلامية في 1989، وتسيطر على البلاد لثلاثين عاماً انتهت بثورة شعبية. وعلى الرغم من أن الأخيرة أيضاً لم تخرج من “الحلقة الشريرة” المعروفة، إلا أن أوجه الاختلاف بين ما حدث في انتفاضتي 1964 و1985 وبين ديسمبر 2018 عديدةٌ، أهمها على الإطلاق هو طبيعة القوى التي تقود هذا الحراك، والمهم كذلك مراعاة الفئة العمرية التي مثلت وقود هذه الانتفاضات. ففي السابق، كانت القوى السياسية التقليدية هي التي تحرّك الشارع وتقوده، بينما ما حدث في ديسمبر 2018 هو أن قطاعات مهنية، ولجان مقاومة لقيادة الشارع تقدمت، ثم لحقت بها الأحزاب السياسية، ولم تتعدَّ الفئة العمرية للشابات والشبان الذين فجروا وقادوا “ديسمبر” الثلاثين في غالبيتهم العظمى.
كان “اعتصام القصر” تمهيد للانقضاض بحجج أن شارع الثورة ليس واحداً، وهناك شارع يرغب صراحةً في أن يمسك البرهان بكل السلطة، وقد كان هذا مطلباً رئيسياً لذلك الاعتصام الذي كان يعج بخطاب الكراهية ضد المدنيين، وفعلياً فهو قد لعب دور “المُحلل” لانقلاب البرهان.
فتحت هذه القوى الحديثة والجديدة كلياً في المشهد السياسي السوداني نافذة أمل كبيرة بعد تضعضع الثقة في القوى السياسية التقليدية، والتي كانت قد اُختبرت في احتجاجات 2013، حينما انفجر الغضب الشعبي عقب إجراءات اقتصادية قاسية، وانتهت إلى لا شيء حينما لم يجد الشارع من يقوده.
القوى الحديثة أمام امتحان تخلّق البديل
حَظي “تجمع المهنيين السودانيين” الذي قاد “ثورة ديسمبر” بالتفاف شعبي لم يحدث له مثيل في التاريخ الحديث للبلاد، ووجدت “لجان المقاومة” (لجان شبابية تشكلت داخل الأحياء) نفسها في مقدمة صفوف المواجهة مع أجهزة البشير القمعية، وقد أبلى هؤلاء الشباب في المواجهة والإصرار والبسالة بلاءً مدهشاً، متمسكين بسلاح السلمية إلى أن غلبت أجهزة البشير التي أسّسها على مدى سنوات على حساب التعليم والصحة.
القوى الحديثة الشابة ذاتها التي انتصرت، وأسقطت حاكماً عسكرياً اعتمد تماماً وكلياً على آلته الدموية هي الآن أمام امتحان النهوض من حالة العجز والفشل التي تلبست النادي السياسي السوداني.
يعتقد كثيرون أن السبب الرئيسي الذي قاد إلى تباطؤ تحقيق مطالب الثورة، وولّد حالة السيولة التي انتهت بانقلاب، يكمن في أن القوى التي قادت الثورة “ترفّعت” عن قيادة الدولة، وعبّدت الطريق أمام النادي السياسي القديم ليعيد إنتاج فشله، ومنحته حق تقرير مصيرها. وهذا الرأي راجحٌ لدرجة كبيرة، لكن، وبالمقابل فإن هذه القوى الحديثة لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة الدولة، كما أنه لم يتخلق منها تنظيم سياسي ينتقل بها من قيادة الثورة إلى قيادة الدولة.
كانت أمام تجمع المهنيين، وبدرجة كبيرة، فرصةٌ تاريخية لقيادة الثورة، لكنه هو الآخر تحول لمرتع خصب لصراعات الأحزاب السياسية التي انقسمت بعد الثورة إلى حكومة ومعارضة. ولأن أساس تكوين تجمع المهنيين هو الكوادر المهنية للأحزاب السياسية، فسرى فيه ما سرى في الأحزاب السياسية: انقسم على نفسه، ضَعُفَ، وانفض الناس من حوله. أما لجان المقاومة فهي الأخرى لم تسْلم من عبث الأحزاب وتنافسها، فانقسمت مواقفها باكراً ما بين داعم للحكومة الانتقالية ومعارض لها. لكن، وفي خضم كل هذا، يبقى الحكم المدني هو هدف الجميع بلا استثناء، وهو المطلب الموحد لكل قوى الثورة حتى وإن انقسمت في المواقف.
لا تزال أمام قوى التغيير في السودان فرصةُ أن يكون انقلاب البرهان آخر الانقلابات. أمامها فرصةٌ تاريخية لكسر طوق هذه “الحلقة الشريرة” وهدم شيطان الانقلابات إلى الأبد، بعد ثبوت عجز النادي السياسي القديم، وعدم رغبته في مواكبة التغيير الذي حدث في شارع “ديسمبر”. وحتى الآن، هناك فجوةٌ واسعة بين النادي السياسي القديم والقوى الحديثة التي قادت “ديسمبر”، وهذه الفجوة هي، بوجهها الآخر، تعبيرٌ صارخ عن صراع جيلين، ويحتاج الأمر إلى عمل دؤوب ومثابرة لا تنقطع لإيجاد حلقة وصل تخلط خبرة القديم وثورية الحديث، كي تتمكن قوى التغيير من وضع لبنات البديل الفعلي الذي يقي البلاد شرور الانقلابات العسكرية الموردة إلى الهلاك